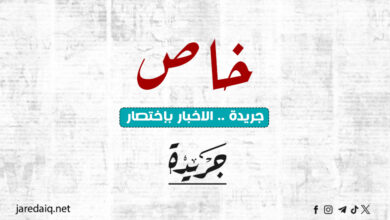الدستور العراقي نص جامد في واقع متغير
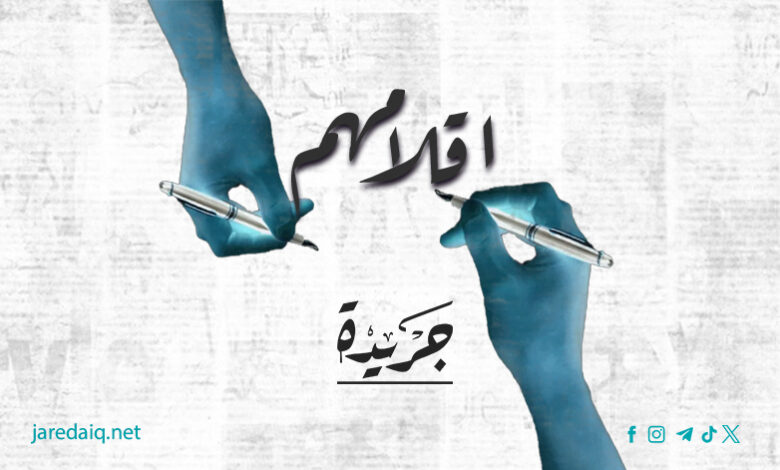
بقلم/ د. باسل حسين
ليس من قبيل المبالغة القول ، ان دستور العراق لعام 2005 لم يكن في جوهره دستورا بالمعنى الكلاسيكي الذي يعبر عن ارادة عليا تتجسد في صياغة تأسيسية ، وانما كان اقرب الى وثيقة سياسية ظرفية محكومة بميزان قوى عابر اكثر مما هي مؤسسة على وعي دستوري عميق وهنا يظهر العجز البنيوي فالنص الذي يفترض ان ينهض بوظيفة الضابط الاعلى انحدر الى مستوى التسوية الموقتة مما افقده الطابع الوظيفي للدستور اي قدرته على التعبير عن التضامن الاجتماعي وضبطه في اطار مؤسساتي مستقر.
إذ يتسم الدستور العراقي بوجود مواطن ضعف متكررة وتعارضات في النصوص فضلاً عن غياب الانسجام بين مواده الأمر الذي أفضى إلى إشكالية معيارية تقوض فاعليته كوثيقة تأسيسية بما يحول دون اضطلاعه بدوره كمرجع أعلى للنظام القانوني والسياسي.
فالديباجة على سبيل المثال لا الحصر بما حملته من خطاب وجداني انشائي لم ترق الى مستوى التعبير عن فلسفة الدولة او تحديد غاياتها العليا، بل كانت نصا مشبعا بالروزخونية السياسية يخلو من العمق المعياري بل انها بلغة النظرية المعيارية ليست سوى قاعدة لغوية خالية من المضمون الاعلى، لانها لم تؤسس نظاما قيميا متماسكا يعلو على السلطة السياسية بل استسلمت للانشاء الادبي.
اما بنية النظام التي ارسى الدستور دعائمها فهي مثال صارخ على النماذج الهجينة التي تولد مشوهة لانها تتارجح بين انماط متعارضة فالنظام العراقي كتب في منزلة ما بين منزلتين ليس دولة مركزية واضحة الملامح، ولا فيدرالية صريحة ذات توزيع متماسك للسلطات، ولا كونفدرالية تعترف بالسيادة المزدوجة.
لقد انتج النص نموذجا مشوها تتنازع فيه المركزية والفيدرالية والكونفدرالية بلا انسجام مؤسسي مما جعله نظاما معطوبا في اساسه، ثم جاءت اليات التعديل لتكرس العجز ذاته، فالمادة 142 افرزت بدعة فيتو ثلاث محافظات، من خلال النص (وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ) وهو قيد يمنح اقلية جغرافية قدرة على تعطيل الارادة الوطنية العامة. ليهدم بذلك سيادة الارادة الشعبية الكلية. اما المادة 126 فقد رفعت عتبة التعديل الى مستوى يكاد يستحيل بلوغه في بيئة منقسمة سياسيا وطائفيا. وهكذا اجتمع القيد الجغرافي في المادة 142 مع القيد العددي في المادة 126 ليشكلا معا منظومة اقفال محكمة، حولت النص الدستوري الى وثيقة جامدة غير قابلة للتطور وفق حاجات المجتمع. اما المادة 65 فقد كشفت عن جهل صريح بفقه الثنائية التشريعية، اذ نصت على انشاء مجلس الاتحاد بقانون يسن من مجلس النواب نفسه وهنا نلمس اختلاط الادوار (السلطة تنشيء ذاتها وتراقب نفسها) في انحدار لمفهوم الفصل بين السلطات الى لعبة شكلية تفتقر الى اي مضمون حقيقي.
هذا المارد النائم من مواد التعديل في الدستور العراقي لم يستيقظ الا في لحظات الانسداد السياسي الكبرى، كما في ازمات تشكيل الحكومات او المطالبات الشعبية بعد احتجاجات تشرين. لكن بدل ان يقود الى اصلاح مؤسسي ظل يفرخ اجتهادات متضاربة للمحكمة الاتحادية العليا، التي اصبحت بحكم غياب الية التعديل الساحة الوحيدة لاعادة تفسير النصوص فاعطت نفسها سلطة تاويلية واسعة جعلت من تسعة قضاة او اقل اوصياء على المسار السياسي برمته ايظهر اثر غياب القاعدة الاساسية، اذ حين يعجز النص عن استيعاب التغير ينتقل مركز الشرعية الى القضاء الذي يملأ الفراغ بقرارات تاويلية غير متجانسة.
ان ما يمكن تسميته فلسفة التعديل الغائبة جعل العراق اسير نظام انتخابي متغير لكنه عقيم وسلطة تشريعية عاجزة عن التمثيل ورئاسة جمهورية محدودة بلا دور فعلي ورئاسة وزراء مشلولة بالفيتوات المتبادلة.
وهكذا تحول الدستور العراقي من اطار معياري اعلى الى وثيقة سياسية اسيرة اللحظة ففقد وظيفته كقاعدة تاسيسية تعلو على الصراع السياسي و لم يعد الدستور معيارا ضابطا بل نصا مؤولا على مقاس القوى النافذة. وهو ما يجعل الازمة العراقية ليست ازمة حكم فقط بل ازمة شرعية دستورية عميقة لان الوثيقة التي كان يفترض ان تؤسس الدولة صارت جزءا من مازقها.