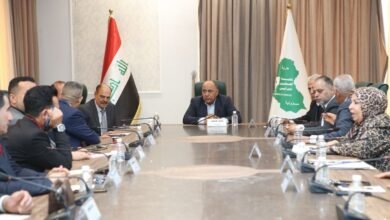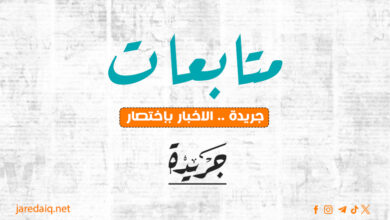إيران وفخ التفريس: دروس الانهيار العثماني
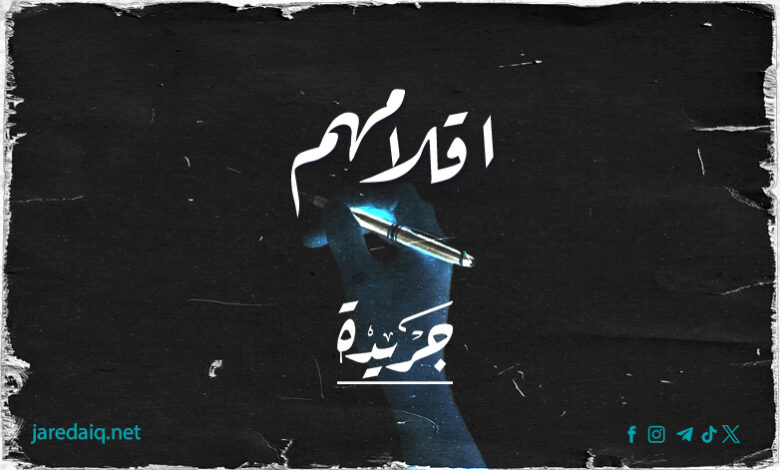
بقلم: علي إبراهيم باخ، باحث و اكاديمي من محافظة دهوك، إقليم كوردستان العراق
شهد مطلع القرن العشرين تحولاً عميقاً في مفهوم الدولة، حيث انتصرت فكرة الدولة-الأمة المتجانسة على النموذج الإمبراطوري متعدد الإثنيات. لم تكن القومية ظاهرة طبيعية، بل كانت مشروعاً سياسياً وثقافياً ونخبوياً يهدف إلى “بناء الأمة” عبر توحيد اللغة والذاكرة ورسم الحدود الرمزية والمادية بين “نحن” و”الآخر”. وفي هذا السياق، جاءت الحرب العالمية الأولى لتكون المختبر الدامي الذي تسارعت فيه هذه المشاريع القومية، فقوضت بشكل جذري شرعية الإمبراطوريات متعددة الإثنيات، وفتحت المجال أمام مبدأ “تقرير المصير” ليصبح الأداة الخطابية والسياسية لإعادة هندسة الخارطة العالمية، مما عنى انتصار تصور الدولة-الأمة على حساب الأنظمة السياسية الأخرى الممكنة.
إن استجابة الدولة العثمانية للتحدي الهيمني الأوروبي في القرن التاسع عشر، والتي تجسدت في سياسة ابتعاث النخب الشابة إلى المراكز الميتروبوليتية، وخصوصًا باريس، لا يمكن قراءتها كعملية نقل معرفي تقني أحادية الاتجاه، بل كحقل ديالكتيكي أنتج مفارقات بنيوية عميقة. فهذه البعثات، التي شكلت الأداة الرئيسية لمشروع “التحديث الدفاعي” في عصر التنظيمات، كانت بمثابة القناة التي تم من خلالها استيراد “تكنولوجيا الدولة” الفرنسية، من إدارة مركزية وقانون وضعي وبيروقراطية حديثة. إلا أن هذا الاستيراد لم يكن محايدًا؛ فالأفكار الجمهورية حول المواطنة والسيادة الشعبية والدولة-الأمة كانت مضمنة عضويًا في هذا النموذج. وعليه، فإن النخبة العثمانية المُستغرِبة وجدت نفسها في قلب تناقض جوهري: فبينما كانت تسعى لاستخدام هذه الأدوات المستوردة لصياغة أيديولوجية فوق-قومية منقذة هي “العثمانية” بهدف تحصين الإمبراطورية ضد التفتت، كانت في الوقت ذاته تتشرب المنطق القومي الذي يجعل من الدولة-الأمة، لا الإمبراطورية متعددة الإثنيات، الشكل النهائي والشرعي للكيان السياسي. وبهذا، تحولت البعثات من استراتيجية للحفاظ على الكيان الإمبراطوري إلى مختبر لإنتاج وتجذير التخيّل السياسي الذي سيقوضه من الداخل، مما يجعل من تجربة التنظيمات مثالًا صارخًا على “المكر التاريخي” الذي تتحول فيه أدوات الإصلاح إلى معاول لهدم البنية التي أُريد إصلاحها.
يمثل صعود “جمعية الاتحاد والترقي” إلى سدة السلطة عبر انقلاب 1908 لحظة القطيعة الإبستمولوجية والسياسية التي تحولت فيها أزمة الإمبراطورية العثمانية من طور الاضمحلال البنيوي إلى طور التفكيك الأيديولوجي الممنهج. فهذه النخبة الجديدة، التي هي ذاتها نتاج سياسات الابتعاث والتحديث الغربية، حملت معها تناقضًا قاتلًا: فبينما كانت تهدف اسميًا إلى إنقاذ “الدولة” من خلال فرض دستور وإعادة هيكلة الجيش والإدارة على أسس مركزية حديثة، كانت في جوهرها قد تخلت عن الفكرة الإمبراطورية الجامعة (العثمانية) التي فشلت في الصمود أمام القوميات البلقانية. لقد جاء الاتحاديون لكي يفرضوا حلاً جذريًا لهذا الفشل، وهو استبدال هوية الإمبراطورية المتعددة بهوية الدولة-الأمة التركية. وهنا يكمن جوهر مساهمتهم في تسريع الانهيار؛ فسياستهم القائمة على “التتريك” القسري للإدارة والتعليم والجيش، لم تكن مجرد سياسة شوفينية، بل كانت محاولة عنيفة لفرض نموذج الدولة القومية المتجانسة على واقع إمبراطوري متعدد الأعراق والأديان. هذا المشروع لم يؤدِ فقط إلى استعداء القوميات غير التركية المتبقية داخل السلطنة، وخصوصًا العرب والأرمن، بل دفعهم بشكل حاسم نحو خياراتهم القومية الخاصة، محولًا إياهم من رعايا يطالبون بالإصلاح إلى أعداء يسعون للانفصال. وبهذا، فإن الاتحاديين، في سعيهم لإنشاء “تركيا قوية”، كانوا في الحقيقة يكتبون شهادة وفاة “الدولة العثمانية”.
تزامنت عملية “التتريك” العدوانية التي قادتها “جمعية الاتحاد والترقي” مع عملية “تأطير قومي” موازية ومضادة، كانت القوى الاستعمارية، وتحديدًا بريطانيا وفرنسا، هي الفاعل الرئيسي فيها. لم تكن القومية العربية فكرة غائبة تمامًا، بل كانت موجودة كتيار نخبوي وثقافي في مدن مثل بيروت ودمشق، لكن التدخل الأوروبي هو الذي حولها من مشروع فكري إلى أداة جيوسياسية. لقد أتقن البريطانيون والفرنسيون لعبة “سياسات الهوية”، حيث عملوا بشكل ممنهج على مخاطبة النخب العربية (مثل الشريف حسين بن علي) ليس بصفتهم مجرد “رعايا” متمردين على السلطان، بل بوصفهم “أمة” ذات تاريخ مجيد وحق في السيادة والاستقلال. لم يكن هذا الخطاب نابعًا من إيمان بمبادئ تقرير المصير، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في “القومية كقوة تفكيكية” موجهة ضد خصمهم في الحرب، الدولة العثمانية. وهنا يتجلى “الخبث” بأوضح صوره: فبينما كانت بريطانيا، عبر مراسلات حسين-مكماهون، تعد الشريف حسين بدولة عربية كبرى وموحدة، كانت دبلوماسيتها في الوقت نفسه ترسم مع فرنسا خطوط اتفاقية سايكس-بيكو (1916) التي تقسم هذه “الدولة الموعودة” إلى مناطق نفوذ وسيطرة مباشرة. لقد كانت القومية العربية في المنظور البريطاني-الفرنسي مجرد وقود لتشغيل محرك “الثورة العربية الكبرى” بهدف إسقاط العثمانيين، على أن يتم التخلص من هذا الوقود وتطلعاته بمجرد انتهاء الحرب. وبهذا، تحقق الهدف المزدوج: استخدام القومية العربية لتدمير القومية التركية الطورانية ومشروعها الإمبراطوري، وفي الوقت نفسه، إجهاض المشروع القومي العربي نفسه لضمان عدم قيام قوة إقليمية موحدة يمكن أن تهدد مصالحهم المستقبلية في المنطقة، وهو ما أسس لقرن من الانقسام والخضوع.
تكشف المقارنة بين النموذج الإمبراطوري العثماني والمشروع الإقليمي الإيراني عن توازيات عميقة وفوارق جوهرية. فبينما استندت الدولة العثمانية إلى الشرعية الدينية السنية العالمية، تواجه إيران حدودًا طائفية أضيق. فالعالمية السنية العثمانية واجهت ثورات مسيحية في البلقان، بينما تواجه الأيديولوجيا الثورية الشيعية الإيرانية حدودًا طائفية صارمة. فالسكان العرب السنة (مثل أولئك في سوريا واليمن) ينظرون إلى “محور المقاومة” الإيراني ليس كتحرير، بل كاستعمار طائفي، مما يُضعف شرعيتها مقارنة بالشرعية الدينية العثمانية الأوسع. وهناك فارق بنيوي مهم: فبينما كان الولاة العثمانيون معينين من الدولة ويخضعون لهيكل إداري مركزي، فإن وكلاء إيران (حزب الله، الحوثيون، الفصائل العراقية) هم فاعلون مستقلون. ولاؤهم نفعي أكثر منه أيديولوجي، مما يجعلهم متقلبين إذا جف التمويل أو إذا أدى “التفريس” في طهران إلى نفورهم. مثال بارز على هذا الاستقلال المتزايد يظهر في سلوك قوات الحشد الشعبي العراقية؛ فواشنطن بوست (يونيو 2025) كشفت كيف أن “الميليشيات القوية الموالية لطهران في العراق بقيت صامتة خلال الصراع الإيراني”، حيث وازنت فصائل الحشد بين المكاسب الاقتصادية والسياسية مقابل الانتقام بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025، مما يُظهر استقلاليتها المتزايدة عن طهران. رينان منصور من تشاتام هاوس (يونيو 2025) يضع قوة الحشد ضمن “إعادة التوازن الإقليمي الأوسع بعد غزة”، مُشيرًا إلى الضغوط من الكتلة الإسرائيلية-الخليجية وصراع بغداد لفرض السيطرة. مركز ستيمسون (مايو 2025) يُوثق مشاريع قوانين أمام البرلمان العراقي لتحويل الحشد من “عبء إلى أصل وطني”، مما يُظهر محاولات العراق لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه القوات وتقليل تبعيتها المباشرة لإيران. بل إن كردستان 24 (مايو 2025) كشفت عن مشروع قانون يهدف إلى “تحويل الحشد الشعبي إلى وزارة مستقلة”، مما يُرسخها في الدولة مع الإجابة رسميًا أمام رئيس الوزراء. هذا التطور يُظهر كيف أن الوكلاء الإيرانيين يسعون للاندماج في الهياكل الرسمية للدول المضيفة، مما يُقلل من سيطرة طهران المباشرة عليهم.
إيران تواجه تحديًا فريدًا لم تواجهه الدولة العثمانية: “لعنة الموارد”. فعائدات النفط والغاز (30% من الميزانية) تُمول الوكلاء، لكن العقوبات وعدم الكفاءة تشل إعادة الاستثمار. وفقًا لتقارير إيران فوكوس (مارس 2025)، فإن ميزانية 2025 خصصت حصة ضخمة من عائدات النفط – تقدر بحوالي 30% – لأجهزة الأمن والحرس الثوري. إيران إنترناشونال (أبريل 2025) كشفت أن الخامنئي والحرس الثوري عززا حصتهما من عائدات النفط والأصول الحكومية بمبلغ 33.5 مليار دولار، مُحولين الموارد من التنمية إلى القمع. وعلى عكس العثمانيين الذين واجهوا أزمات ديون، تواجه إيران اعتمادًا على النفط يخنق التنويع الاقتصادي، مما يُسرع الانهيار عندما تنخفض العائدات. التضخم الذي يتجاوز 39.4% سنويًا (وفقًا لوكالة ترند الإخبارية، يونيو 2025) يُآكل دعم الطبقة الوسطى، بينما يصل التضخم في المواد الغذائية الأساسية إلى 284% (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يونيو 2025). العقوبات تحجب احتياطيات النقد الأجنبي، مما يُكثف الألم الداخلي ويُغذي احتجاجات جديدة في جميع المحافظات الإيرانية الـ31 تحت شعار “لا ضوء، لا ماء، لا مستقبل”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأقليات غير الفارسية في إيران (الأذريون، الكورد، العرب) تشكل 40% من السكان. “التفريس” قد يُشعل الانفصالية – وهذا يختلف عن الأناضول العثماني الذي كان أغلبيته تركية. تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي 2025 (يناير 2025) وثق التمييز المنهجي ضد الكورد والبلوش والعرب والسنة، بينما حذر خبراء الأمم المتحدة (أغسطس 2024) من أن الأقليات “تحملت العبء الأكبر” من حملات القمع. على الصعيد الجيوسياسي، خلقت اتفاقيات إبراهيم كتلة سنية-إسرائيلية ضد إيران، تُحاكي التحالفات الأوروبية ما قبل الحرب العالمية الأولى التي عزلت العثمانيين. دراسة مؤسسة كارنيغي (أبريل 2025) بعنوان “اتفاقيات إبراهيم بعد غزة” تُظهر كيف حافظت الإمارات والبحرين والمغرب على علاقاتها رغم حرب غزة، مُكثفةً منطق الحصار. إسرائيل هيوم (يونيو 2025) تتوقع دخول السعودية وحتى سوريا ولبنان إلى الاتفاقيات بعد أحدث الضربات الأمريكية/الإسرائيلية على إيران. نيويورك بوست (يونيو 2025) تُحاجج بأن الضربات الأخيرة تركت طهران معزولة وأعطت واشنطن نفوذًا لتوسيع الاتفاقيات. وعلى عكس القوى الأوروبية التي قسمت العثمانيين، فإن روسيا والصين تستغل إيران كبيدق لكنهما لن تُنقذاها؛ استثماراتهما تركز على الاستخراج وليس الاستقرار.
وصف وول ستريت جورنال (يونيو 2025) بدقة كيف أنه “بمجرد توقف القنابل الأمريكية والإسرائيلية عن الهطول على إيران، ظهر القادة الثيوقراطيون وقوات الأمن من مخابئهم وبدأوا في شن حملة جديدة – هذه المرة ضد شعبهم، مستهدفين الجواسيس المزعومين والمعارضين وشخصيات المعارضة”. لقد انتشرت نقاط التفتيش في جميع أنحاء طهران بينما تسعى السلطات لاستعادة السيطرة ومطاردة الأشخاص الذين تشتبه في مساعدتهم للهجمات الإسرائيلية. اعتقلت الشرطة وضباط المخابرات المئات، وتواصل احتجاز المزيد يومياً. الشرطة شبه العسكرية المسلحة تقوم بدوريات في الشوارع، والناس يتم إيقافهم وتفتيش سياراتهم وهواتفهم وحواسيبهم. الأهم من ذلك، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أخبرت السكان بالإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة، ووزعت مجموعة من النصائح حول كيفية اكتشاف الجاسوس. منظمة العفو الدولية تشير إلى أن أكثر من 1000 شخص تم احتجازهم خلال الأسبوعين الماضيين لمساعدة إسرائيل مزعومة. الحكومة أعلنت عن إعدام متسرع لستة رجال على الأقل. وزارة الصحة الإيرانية قالت إن أكثر من 600 شخص قُتلوا وأكثر من 4800 أُصيبوا خلال الحرب. كما يشير التقرير، فإن “شرطة الأخلاق عادت”، حيث قالت امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً هربت من طهران خلال الحرب: “الشرطة حتى أوقفتنا واستجوبتنا، لأن جوارب المرأة التي معي كانت شفافة جداً”.
كشفت الهجمات الأخيرة عمق اختراق جهاز الموساد الإسرائيلي لإيران. كما يوضح محمد أمين نجاد، السفير الإيراني في فرنسا، لقناة فرانس 24: “الإسرائيليون نظموا اختراقات، ونقل قنابل ومتفجرات، وجندوا أشخاصاً من الداخل… حدث هذا أمام أعيننا مباشرة. كانت هناك نقاط ضعف”. في هذا السياق، فإن ظهور خطاب داخل الأوساط الإيرانية يلقي باللوم على العناصر الأجنبية المتحالفة معها (العرب، الأفغان، الباكستانيون) ليس مجرد محاولة لإيجاد “كبش فداء” لتبرير الإخفاقات الأمنية، بل هو مؤشر على انهيار الثقة التي تشكل المادة اللاصقة لمشروع النفوذ الإقليمي. فالفكرة القائمة على “وحدة الولاء الشيعي” العابر للحدود، والتي كانت مصدر قوة لإيران، تظهر علامات مبكرة للتحول في ظل الارتياب والشك إلى مصدر تهديد. يُنظر إلى الحليف الذي كان بالأمس عمقاً استراتيجياً على أنه اليوم “طابور خامس” محتمل. هذا التحول في الخطاب خطير للغاية لأنه يقوم بتفكيك الأيديولوجية من الداخل؛ فبدلاً من أن يكون “الشيعي الأجنبي” امتداداً للثورة، يصبح ثغرة أمنية. هذه الديناميكية لا تكشف عن قوة أجهزة الاستخبارات المعادية فحسب، بل تكشف عن بداية تآكل المشروع الأيديولوجي الإيراني نفسه، حيث يحل منطق الشك الأمني القومي الضيق محل منطق الثقة العقائدية العابرة للحدود. إنه بالضبط ما يحدث عندما تبدأ الإمبراطورية في استشعار نهايتها؛ فتتوقف عن النظر إلى الخارج بحثًا عن الفرص، وتبدأ في النظر إلى الداخل بحثًا عن الخونة. هنا يكتمل التشابه المنهجي مع الخطأ التاريخي القاتل الذي ارتكبته الدولة العثمانية. كما اختارت النخبة العثمانية التتريك كحل يائس، تختار طهران اليوم التفريس بدافع جنون الارتياب الأمني—وهو خيار يُسرع الانهيار لا يُبطئه. إن النتيجة الحتمية لسيادة منطق الشك الأمني على الأيديولوجيا الجامعة هي الانكفاء نحو النواة الإثنية الصلبة باعتبارها الملاذ الأخير للثقة. فكما أدى فشل “العثمانية” وهزائم البلقان إلى ارتماء نخبة الاتحاد والترقي في أحضان “القومية الطورانية” كعقيدة خلاص، فإن الفشل الاستخباراتي المتكرر والارتياب في ولاء الحلفاء الشيعة غير الإيرانيين قد يدفع، وبشكل متسارع، دوائر القرار في طهران إلى الاعتماد الحصري على “العنصر الفارسي” كضامن وحيد للولاء. وهذا هو “فخ التتريك” ذاته: ففي اللحظة التي تبدأ فيها الدولة بالتعامل مع حلفائها وأبناء مشروعها الأيديولوجي (العرب، الأفغان، وغيرهم) على أنهم “جواسيس مفترضون” وتهديدات أمنية، فإنها تقوم عمليًا بتفكيك شبكة نفوذها بيدها. إنها بذلك لا تحارب الخيانة بقدر ما تصنعها، فالحليف الذي يتم تهميشه والتشكيك في ولائه لن يجد سببًا للبقاء مخلصًا. هذا الانكفاء نحو “الفرسنة” كسياسة أمنية، سيؤدي حتمًا إلى نفور الحلفاء الذين يشكلون عمقها الاستراتيجي، وسيحولهم من أصول قوة إلى أعباء، أو حتى إلى أعداء في المستقبل. وبذلك، تكون إيران قد كررت المأساة العثمانية بحذافيرها: محاولة إنقاذ “الإمبراطورية” عبر التخلي عن فكرتها الجامعة، مما لا يؤدي إلا إلى تسريع انهيارها، فتكون بذلك قد اختارت الهروب من الخطر الخارجي بالانتحار السياسي الداخلي.
إن سقوط القوى الكبرى والإمبراطوريات ليس حدثاً دراماتيكياً مفاجئاً بقدر ما هو عملية بنيوية معقدة ومتعددة الأبعاد، يمكن فهمها كنتاج لتفاعل قاتل بين الطموح الجيوسياسي، والواقع الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي. لفهم هذه السيرورة، لا يكفي النظر إلى المؤامرات أو الهزائم العسكرية المعزولة، بل يجب تشريحها عبر دمج نماذج من علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع. ومن خلال هذا التحليل المتكامل، يمكننا رؤية كيف أن مصير الدولة العثمانية في الماضي، والمخاطر التي تواجه القوى الإقليمية الطامحة مثل إيران اليوم، تتبع مساراً منطقياً يمكن التنبؤ به. فالضغط الخارجي والتمدد المفرط يستنزفان الاقتصاد، وهذا الاستنزاف الاقتصادي يولد سخطاً داخلياً. وفي محاولة لاحتواء هذا السخط وتوحيد الصف، تلجأ الدولة إلى فرض هوية قومية ضيقة، فتُقصي وتُهمش المجموعات الأخرى التي كانت تشكل جزءاً من نسيجها الإمبراطوري. هذه المجموعات المهمشة، التي فقدت ثقتها بالمركز، تتحول من رعايا أو حلفاء إلى قوى انفصالية، فتنهار الإمبراطورية ليس فقط بفعل ضربات العدو الخارجي، بل بفعل تفككها من الداخل في سلسلة من ردود الفعل القاتلة التي بدأت هي نفسها بإطلاقها. عندما تقوم جماعة إثنية مهيمنة في دولة متعددة الأعراق بفرض هويتها كـ”هوية وطنية” وحيدة (مثل التتريك)، فإن هذا لا يؤدي إلى اندماج باقي الجماعات بل يخلق ردود فعل دفاعية. الجماعات الأخرى (العرب، الأرمن، الكورد) التي تشعر بأن هويتها ولغتها وثقافتها مهددة، تبدأ هي الأخرى في “تخيل” وبناء هويتها القومية الخاصة كـ”مشاريع مضادة” للمشروع المهيمن. سياسة “التتريك” لم تخلق أتراكًا من العرب، بل سرعت في خلق “قوميين عرب” رأوا أن الخلاص الوحيد لهويتهم هو الانفصال وتأسيس دولة خاصة بهم. وهذا بالضبط هو الخطر الذي يواجه إيران إذا ما قررت، تحت ضغط الشك الأمني، الانكفاء نحو “الفرسنة” وتهميش حلفائها من القوميات الأخرى. هذا لن يجعلهم أكثر ولاءً، بل قد يدفعهم إلى البحث عن مشاريعهم الخاصة، محولًا إياهم من حلفاء إلى خصوم.
علامات الانهيار المبكرة تتجلى في التشكيك المتزايد في ولاء الحلفاء غير الفرس؛ فعندما تبدأ طهران في النظر إلى حزب الله أو الحوثيين أو الفصائل العراقية على أنهم مصدر تسريب أمني محتمل بدلاً من امتداد للثورة، فإن هذا يعني أن الأيديولوجيا العابرة للحدود التي شكلت أساس المشروع الإيراني تتآكل من الداخل. وثانياً، تحويل الموارد من المشاريع التنموية والاقتصادية إلى أجهزة الأمن ومكافحة التجسس، وإن بدا منطقيًا في ظل التهديدات الأمنية، إلا أنه يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي ومزيد من السخط الشعبي، مما يخلق حاجة لمزيد من القمع الأمني في حلقة مفرغة. وثالثاً، تراجع جاذبية النموذج الإيراني في المنطقة. فالانتفاضات في إيران نفسها، وخاصة حركة “المرأة، الحياة، الحرية”، قوضت صورة إيران كـ”نموذج للمقاومة” وكشفت عن هشاشة داخلية عميقة، وهذا التراجع في القوة الناعمة يجعل من الصعب على إيران جذب حلفاء جدد أو حتى الحفاظ على ولاء الحلفاء الحاليين. وأخيراً، الاعتماد المتزايد على القوة العسكرية والتهديد بدلاً من الإقناع والتأثير الأيديولوجي، وهذا التحول من “إمبراطورية بالموافقة” إلى “إمبراطورية بالإكراه” يشير إلى ضعف أساسي في المشروع ويزيد من تكاليفه بشكل كبير.
تتعدد سيناريوهات انهيار إيران المحتملة. السيناريو الأول هو الانهيار عبر العقوبات والتضخم المفرط، حيث يؤدي انهيار العملة إلى تضخم جامح يصل لمستويات الأرقام الثلاثة، مما يُثير اضطرابات شعبية واسعة، فاحتجاجات 2022-2023 كانت مجرد معاينة لما قد يأتي. عندما يفقد المواطنون قدرتهم على شراء الحاجات الأساسية، ستنهار شرعية النظام الاقتصادية قبل شرعيته السياسية. السيناريو الثاني هو هجران الوكلاء؛ فإذا واجه حزب الله والحوثيون هزائم حاسمة، فقد ينهار “المحور” مُظهرًا الفراغ الاستراتيجي. معهد واشنطن (ديسمبر 2024) حذر من أن طهران يجب الآن “إعادة تكوين حزب الله في ظروف أصعب”، مما يُؤكد ادعاء “الولاء النفعي”. الحالة العراقية تُظهر هذا التحول بوضوح، حيث وثقت رويترز وأسوشيتد برس (يناير 2024) كيف أن الضربات الأمريكية على قادة كتائب حزب الله وضعت بغداد في مأزق عندما استهدفت وحدات من الحشد الشعبي مُدرجة رسميًا في كشوف رواتب الدولة لكنها تعمل خارج سيطرة الدولة. الوكلاء الذين يعتمدون على التمويل الإيراني قد يبحثون عن رعاة جدد أو يتفاوضون بشكل منفرد، تاركين إيران معزولة. السيناريو الثالث هو الخطأ الحسابي العسكري والحرب السيبرانية؛ فحرب مباشرة بين إسرائيل وإيران قد تُدمر القوات الجوية والبحرية الإيرانية في أيام (وفقًا لمحاكاة مؤسسة راند)، مما يُحطم مصداقية النظام. فقدان القوة الصلبة بسرعة قد يُؤدي إلى انتفاضات داخلية حيث تفقد النخبة الحاكمة أداتها الأساسية للسيطرة. هذا السيناريو لم يعد افتراضياً بل واقعاً حدث مؤخراً. وول ستريت جورنال (يونيو 2025) يوثق كيف أن نتنياهو “راهن رهانًا ضخمًا في مواجهة إيران. وقد نجح الرهان”، حيث أمر القوات الجوية الإسرائيلية بضرب إيران منفردة، دون أي ضمان بأن الولايات المتحدة ستنضم وتساعده في إنهاء المهمة. العملية، التي استمرت 12 يوماً، “أثبتت التفوق العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي على إيران، وغيرت توازن القوى في الشرق الأوسط وأكدت مكان إسرائيل كقوة عظمى في المنطقة”. وللمرة الأولى في التاريخ الطويل للعلاقات الوثيقة بين البلدين، انضمت القوات الأمريكية إلى حملة عسكرية إسرائيلية، موفرة القوة النارية الهائلة اللازمة لإكمال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. كما كشفت وول ستريت جورنال (يونيو 2025) كيف أن “القراصنة المتحالفين مع إسرائيل شلوا النظام المالي الإيراني”، حيث استهدفت السلطات الإسرائيلية ومجموعة القرصنة الموالية لإسرائيل “العصفور المفترس” (Predatory Sparrow) المؤسسات المالية التي يستخدمها الإيرانيون لتحريك الأموال وتجاوز الحصار الاقتصادي. هذه الهجمات استهدفت ما وصفته المجموعة بـ”شرايين الحياة المالية” للحرس الثوري الإيراني. وردت الحكومة الإيرانية بقطع الكثير من الأنشطة الإلكترونية لمنع المزيد من الهجمات واحتواء الاضطرابات. هذا الانقطاع الرقمي، المقترن بالعقوبات الاقتصادية والتضخم المرتفع، يُظهر هشاشة البنية التحتية الإيرانية أمام الهجمات متعددة الأبعاد.
إن التاريخ يعلمنا أن أي إمبراطورية تتخلى عن هويتها الجامعة العابرة للحدود وتنكفئ نحو هوية إثنية أو قومية ضيقة، فإنها تحفر قبرها بيدها. الإمبراطوريات تقوم على التنوع والشمولية، وعندما تتحول إلى مشاريع قومية ضيقة، فإنها تفقد مبرر وجودها. النجاح الإمبراطوري يتطلب توازنًا دقيقًا بين تكاليف الحفاظ على النفوذ والمنافع المحققة منه. عندما تتجاوز التكاليف المنافع، تبدأ عملية الانحدار. وهذا يتطلب من القادة الإمبراطوريين قدرة على التقييم الواقعي لحدود قوتهم وعدم الانجرار وراء طموحات تفوق إمكانياتهم. الحكمة تكمن في معرفة متى نتوقف، لا متى نتوسع. وعندما تبدأ الإمبراطورية في رؤية الأعداء في كل مكان، بما في ذلك بين حلفائها، فإن هذا يشير إلى بداية النهاية. جنون العظمة الأمني يؤدي إلى قرارات غير عقلانية تسرع من عملية الانهيار بدلاً من منعها. الثقة، وليس الشك، هي أساس أي تحالف مستدام. مع ذلك، يجب الاعتراف بوجهة نظر متوازنة. فناريس باجوقلي، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، تُحذر من التسرع في الحكم: “كان هذا واحداً من أخطر الخروقات الأمنية في تاريخ النظام، لكنه لم يكن نقطة تحول. القيادة صمدت، والشوارع بقيت هادئة، والنظام أثبت مرة أخرى أنه مبني ليس للشعبية، ولكن للبقاء”. وتضيف باجوقلي: “نظام إيران مبني لتحمل الصدمات. النظام لم ينهار. إنه يتكيف، والكوادر الأصغر سناً من الحرس الثوري وشبه العسكريين يتولون المسؤوليات – كثير منهم أكثر تشدداً من أولئك الذين قُتلوا”. هذا التحليل يُذكرنا بأن الأنظمة الاستبدادية قد تخرج أقوى وأكثر قمعية من الأزمات. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن إيران تمتلك عوامل مقاومة فريدة لم تكن متاحة للدولة العثمانية. فقدراتها السيبرانية والصاروخية المتقدمة، بالإضافة إلى تضاريسها الجبلية الوعرة، تجعل الغزو الأجنبي أكثر تكلفة مما كان عليه ضد العثمانيين. كما أن شبكة حلفائها غير الرسمية، رغم هشاشتها، توفر عمقًا استراتيجيًا ومرونة في المناورة. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني، رغم معاناته من العقوبات، لا يزال يحتفظ بقاعدة صناعية وتكنولوجية أكثر تطورًا من تلك التي كانت متاحة للعثمانيين في أواخر عهدهم. هذا يعني أن عملية الانحدار قد تكون أبطأ وأكثر تعقيدًا من النموذج العثماني. ختاماً، هذه النماذج العلمية تظهر لنا أن انهيار القوى الكبرى ليس حدثًا مفاجئًا أو مجرد مؤامرة، بل هو عملية بنيوية يمكن تحليلها وفهمها. إنه تفاعل معقد بين الاستنزاف الاقتصادي (التمدد المفرط)، والضغوط الخارجية (العقوبات والحروب)، والتفكك الاجتماعي الداخلي (صراع الهويات). مسار إيران الحالي يعكس التجربة العثمانية بدقة مذهلة. فالتحول من التوسع الواثق إلى الانكفاء المرتعب، وتزايد عدم الثقة في الحلفاء غير الفرس، والعبء الاقتصادي المتزايد للحفاظ على النفوذ الإقليمي، كلها تشير إلى نفس النمط التاريخي الذي دمر الإمبراطورية العثمانية. إن التحدي الذي يواجه النخب الحاكمة في طهران اليوم ليس مجرد تحد تكتيكي أو عسكري، بل هو تحد وجودي يتعلق بطبيعة المشروع الإيراني نفسه. فالاختيار بين الحفاظ على الطابع الإمبراطوري العابر للحدود والانكفاء نحو الهوية الفارسية الضيقة ليس مجرد قرار سياسي، بل هو تحديد لمصير الدولة الإيرانية في المدى الطويل. إن الدروس العثمانية واضحة: الإمبراطوريات التي تحاول إنقاذ نفسها عبر التخلي عن طابعها الجامع تسرع من انهيارها بدلاً من منعه. فالقوة الإمبراطورية تكمن في قدرتها على استيعاب التنوع وتحويله إلى مصدر قوة، وليس في محاولة قمعه أو إلغائه. إن “فخ التفريس” الذي يبدو أن إيران تقترب منه تدريجياً ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل هو انتحار سياسي. فالدولة التي تعامل حلفاءها كخونة محتملين تصنع خيانتهم بيدها. والأيديولوجية التي تتحول من رسالة جامعة إلى أداة شك وارتياب تفقد قدرتها على الإلهام والتعبئة.